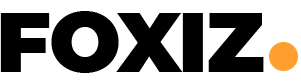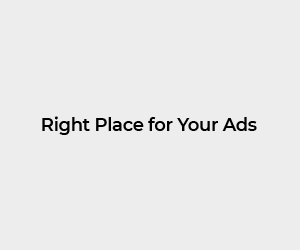عرف المشهد التصويري المغربي وما يزال، نماذج إبداعية متنوعة التكوين، والثقافة، والحساسية، والاختيار، والإنجاز، وطرق التعبير؛ كما تميز ببروز ذوات قررت المشاركة في حقل الإبداع البصري بطرق حرص فيها أصحابها، وباستماتة مثيرة، على الالتزام بها والإصرار على التشبث بها، على الرغم من الإغراءات كافة، ومن التحولات التي تحصل على منطق العرض، والمشاهدة، والتداول. وذلك منذ بدايات الممارسة التشكيلية المغربية، مرورا بمحطة مدرسة الدار البيضاء، وما ارتبط بها من أسئلة حول الذاتية، والهوية الوطنية، والتراث قياسا إلى النماذج المرجعية لأوروبا، وتقنياتها، ومدارسها؛ وما تميزت به التجارب التصويرية لمدرسة الفنون الجميلة بتطوان من أساليب مختلفة في الإنجاز، والعرض والخطاب، إلى ما تعرفه الساحة التشكيلية، اليوم، من ذاتيات، وتقنيات، ومغامرات إبداعية في غاية التنوع والتباين، سواء على مستويات الأشكال أو الدلالات، أو نمط العرض والحضور.
غير أن الممارسة التصويرية المغربية لم تعرف تجربة تشبه التجربة الاستثنائية للفنان خليل الغريب من حيث الرؤية، والمسار، والعرض، والتعليل؛ فهو يُعتبر “ظاهرة” فنية لثلاثة أسباب رئيسية؛ أولها، لكونه دخل العمل التشكيلي، في أواسط ستينيات القرن الماضي، بشكل عصامي توجهه اندفاعة شخصية وتصورا خاصا لِما يمكن أن يقوم به مقارنة مع ما كان ينجز في هذه الفترة من أعمال تصويرية، وقياسا إلى ما كان ينتج من خطابات حولها؛ ثانيا، أنه اختار الانتباه إلى ما يعتبره الجميع مُستبعدًا، مرميًا على الرصيف والهامش، وما يرمي به البحر على جنباته المتموجة، وما يقوم به من تحويل للصخور، والأشياء، وما يعرضه للتفكك والتلاشي.
يلتقط خليل الغريب في تنقلاته ما يهمله الآخرون في أماكن لا يكترث بها الناس، ويجمعها ويراكمها في مخْزنه، ليجعل منها مادة لا يتوقع أحدا أن عناصرها يمكن أن يتشكل منها عملا فنيا، أو تُبنى بها لوحة، أو تتأثث بها مُنشأة. هكذا يبني خليل أعماله الفنية بغير مواد الصباغة والأكلريك المعروفة، أو ما يستعمله الآخرون في رسم لوحاتهم وصباغتها؛ والسبب الثالث يتجلى في أنه قرر، وباعتقاد لم يتزحح عنه منذ خمسين سنة، ألاَّ يعرض أعماله للبيْع، مهما كانت الجهة أو المؤسسة التي تتقدم لطلب أعماله؛ بما فيها كبريات مؤسسات المزاد العلني ك”كريستيز”، وغيرها. واستمر في إصراره على أن يكون، هو، من يمتلك مصير لوحاته وأعماله، وعلى منحها لِمن يقرر منحها له، سواء أكانت متاحف، أو أشخاصا.
وما يثير في خليل الغريب أنه، وإن لم يتهافت على الإعلام وقنوات التواصل المتنوعة، فإن مجالسته والاستماع إليه تجعلك تلاحظ أنك أمام مثقف واسع المعرفة، واثق من اختياراته، مستند إلى مرجعيات فلسفية وصوفية لا يتردد في الإعلان عنها، من قبيل تأثره بفلسفات الشرق الأقصى، والتصوف الإسلامي؛ كما أن قاموسه العربي السيَّال والمتدفق يختزن أفكارا في منتهى الوضوح والشاعرية، بفضل قراءاته الواسعة للأدب، وممارسته التعليمية. فهو لا يستعمل مصطلح “الهشاشة”، التي تُميز الأجزاء والمواد والكائنات التي يشتغل عليها، للتدليل على حالة من حالات الضعف، والعيب، أو النقصان؛ بل على العكس من ذلك، يرى فيما يبدو هشًّا يختزن قوة يتعين استخراجها، وتشغيلها، أو على الأقل الانتباه إليها.
ويعتبر أن عملية التجميع، والفرز، والتأثيث، والتزويق، دائما اعتمادا على عناصر طبيعية كالجير والنيلة والنخالة وغيرهما، هي عملية تتم عنده من دون سابق تخطيط؛ وأن إنشاء ما ينشئ هو نتاج لعب جدِّي يعبر عما يجيش في دواخله، وما يتفتق عن مُتخيله، وما يتفجر من أحاسيس كامنة لديه في سياق شطْح روحي وتوتر جسدي يفضي، في الأخير، إلى ما يمكن اعتباره منجزًا يوفر ما يفيد الاطمئنان إليه.
لعل أسلوب اشتغال خليل الغريب، ومقاومته لاشتراطات العرض والطلب، ولإغراءات المساومات المالية، وعزوفه العجيب عن التهافت وراء الاعتراف، جعل منه فنانا متفردا في المشهد التشكيلي المغربي، وحالة فنية تُحير الصحفيين، والنقاد، وتجار اللوحات والوسطاء. وباعتباره قليل الكلام والمقابلات، فقد كان موضوع عدد لا بأس به من المقالات والكتابات. لكن ما صاغه إدموند عمران المالح في كتابه “العين واليد” (وهو كتاب نتج عن حوارات طويلة ومتعددة بين الرسام والكاتب، لكنها حوارات بواسطة ما قدمه خليل الغريب من رسوم، وما سمحت لإدموند عمران المالح من انفتاحات، وإيحاءات، ومعاينات، وقد نشر سنة 1993 بباريس)[1].
يتعلق الأمر في هذا الكتاب “الخاص” بلقاء نادر بين مُبدع في الرسم: خليل الغريب، وكاتب متذوق للتصوير المغربي: إدموند عمران المالح. اختار الأول ممارسة الفن وتشكيل الصور والأشياء داخل عالم يرفض فيه أن يكون للخارج الكلمة الفصل؛ حيث جعل من هاجس الإنصات إلى الذات نبراسه، وسبيله الوحيد. أما الثاني فإن فعل الكتابة لديه ترجمة لتجذر ثقافي وانغماس متوتر في لعبة الرموز والذاكرة. يعاند الغريب فعل التوقيع ويرفض منح الأسماء والعناوين للوحاته، ويجتهد المالح لتدقيق طبيعة الإدراك والكشف عن كثافة الخطوط والأشكال والألوان. هكذا أصر إدموند عمران المالح على جعل هذا الكتاب يرقى إلى مستوى الاحتفال العمومي برسام مغربي بقي مدة طويلة يتحفظ، بحكمة لافتة، على الأساليب المتعارف عليها في عرض أعماله، وفي تداولها بالصيغ المتواطئ عليها في التداول.
يشكل كتاب “العين واليد” تمثيلا لكتابة عاشقة عن فنان مُلغز، ومحاولة لتلمُّس بعض منابع الأسرار الإبداعية لخليل الغريب، وكشْفا لِما يشكل حريته اللامتناهية في الفعل الفني، ولدلالات زهده المعهود في الظهور. وحين قرر إدموند عمران المالح الكتابة عن الغريب فلأنه نظر إلى أعماله بعين لا تحركها إدراكات جمالية محض؛ وإنما بعين مُتابِعة لمجال الممارسة التشكيلية المغربية، ومهتمة بالتموجات الثقافية والرمزية والتاريخية التي أعطت لهذه الممارسة مضامينها، وأبعادها الجمالية، ومنحتها أصداءها المعروفة.
يعتبر المالح، منذ مُفتتح كتابه، أن الحركة التشكيلية المغربية وصلت إلى ما نعَته، في بداية تسعينيات القرن الماضي، بمرحلة “زهْرة العمر”؛ أي فترة “الشباب المليء بالحيوية”، وذلك على الرغم من العمر القصير الذي مرَّ على بداياتها. وهو في ذلك يستبعد الرأي القائل إن المغرب لا يمتلك تراثا تشكيليا، وبأن المصور المغربي انحنى، في يوم من الأيام، أمام السند بفضل التأثير الحاسم للحضور الكولونيالي. والحال أن المرء يجد نفسه إزاء أعمال رسامين مغاربة كبار منحوا لهذا الحقل الإبداعي أشكالا وألوانا ودلالات وحساسيات لم تكن متوقعة، لدرجة يشعر المتتبع لمساراتها أنه منغمر بالرسم وبمختلف تمظهرات الإبداع البصري. فجيل فريد بلكاهية، ومحمد المليحي، وأحمد الشرقاوي، والجيلالي الغرباوي، وميلود الأبيض، ولحسن الميلودي، ومحمد القاسمي، وعبد الكبير ربيع، وعبد الله الحريري، وآخرون، والجيل الذي واكبهم، والذي جاء من بعدهم يمثلون نماذج وصورا دالَّة، متنوعة، وراقية للرسم الحديث والمعاصر في المغرب.
ولكن ما معنى التصوير؟ ما هي حقيقته؟ وأين يمكن استجلاء مميزاته وكيف؟ وهل يمكن لعمل فني أن يكشف عمَّا يختزنه من رموز وصور وأشكال؟
تلح هذه الأسئلة على كل من يقترب ذهنيا وفكريا من ألغاز اللوحة؛ فهي تعكس بعض مظاهر التوتر في المواجهة بين ذاتية المبدع، بكل رغباته وشطحاته وأحلامه، وبين العناصر المادية التي يتطلع إلى تحويلها إلى أشكال وخطوط ورموز وكائنات. وهو الأمر الذي دفع إلى القول إن مسألة المحاكاة لا معنى لها داخل التشابك الرمزي والدلالي الهائل الذي تولده حركات الفنان داخل عمله الفني.
اعتبر المالح أن غِنى الحركة التشكيلية، منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، لم يكن يسمح مع ذلك بالحديث عن تيارات أو مدارس، حتى وإن وجدنا أعمالا تُوحي بالتجريدية، أو التشخيصية، أو الواقعية، أو تجارب تعكس تقاطعات متنوعة الأشكال بين هذه التيارات. إلا أن حيوية هذه الحركة سمحت، وتسمح ببروز أسماء وتوقيعات جديدة تغني الحركة، وتمنحها تنوعًا أكبر. ولا يعني تسجيل هذه المعاينة، البتة، أن كل وافد على الحركة يحمل جديدا معه بالضرورة؛ فنحن نشهد على عرض أعمال بعيدة عن فعل الإبداع، وإنتاج سيئ، وتجارب ينقصها النضج؛ ومع ذلك تجد من يمجدها، ويعلي من شأنها، مستعملا كل ما يملك من تبريرات بلاغية مُقعَّرة ولا معنى لها.
يتعلق الأمر بظواهر منتظرة ومعروفة على كل حال، وهي حالات تتسرب لكل الحقول الإبداعية؛ غير أن المالح لا يناقش هذه القاعدة عند حديثه عن حيوية التصوير المغربي، لأنه يلح على قاعدة واضحة مفادها أن ما يمثل أصالة هذا التصوير يتجلى في الإمكانية التي يوفرها للمرء في الحكم عليه من داخله وليس بالإحالة على ما ينجز من أعمال في مراكز التصوير العالمية مثل باريس، ولندن، ونيويورك. ولذلك دعا إلى ما أسماه “ثورة حقيقية” في النظر إلى هذه الأعمال ومقاربتها انطلاقا من دينامياتها الإبداعية والرمزية، والدلالية، والثقافية التي تميزها، والانتباه إلى الشروط الفكرية والجمالية المطلوبة للحكم عليها.
لقد عمِل إدموند عمران المالح على تسجيل ملاحظاته وآرائه عن الوضع التشكيلي العام من أجل الوقوف عند ظاهرة الفنان “خليل الغريب”؛ وهي عنده ظاهرة برزت، بهدوء وثقة ومن دون ضجيج في ثمانينيات القرن الماضي؛ وإن كان الغريب سبق له أن عرض قبل ذلك. وهي ظاهرة إبداعية، عند المالح، تتقدم إلى المشاهدة البصرية كحالة فريدة، في شكل أعمال، ولوحات، ومُجسمات، ومنشآت. وهذا ما سمح له بالقول إن الغريب يحتل موقعا أصيلا في التصوير المغربي؛ بل ويمثل إحدى القيم البارزة في الممارسة التشكيلية المغربية. لم يكن هذا الفنان معروفا على نطاق واسع؛ ليس لأنه كان في بداية مشواره أو هو في حاجة إلى التعريف به حين قرر المالح تحرير كتاب “العين واليد” بتنسيق مع الغريب، أو هو من صنف أولئك الرسامين الذين يبرزون بفضل الارتجال والصخب الإعلامي، أو التهافت على من يكتب عنهم. ذلك أن الغريب كان يخفي وما يزال أعمالا هائلة، لأنه بكل بساطة، أو بكل غرابة كما يقول المالح، يرفض منطق العرض السائد؛ علما أنه يدرك، حق الإدراك، ما تستلزمه آليات العرض ومساوماته. لا مجال للتفاوض بالنسبة إليه حول رغبة الآخر، أو طلب الاستجابة لما يريده هذا الآخر؛ غير أنه بسبب إلحاح من يعتبرهم أصدقاء استسلم، في الأخير، لقوة الصداقة بقبول عرض أعماله، لكن مع التشبث الصارم برفضه بيْع أي عمل من أعماله.
بهذا الموقف خلق خليل الغريب إزعاجا لأكثر من جهة وما يزال؛ وحين قبِل بعرض أعماله تحت إصرار بعض أصدقائه، لم يكن ذلك من أجل التداول المادي، بل استجابة لانتظار إنساني عميق بالغ الدلالة في تعبيراته الوجودية. فهو يفضل العطاء بوصفه أسمى فعل في التواصل الإنساني؛ وهو عطاء لا يضمر أي شكل من أشكال المقايضة، بمقدار ما يحمل معنى رمزيا إنسانيا. ففي عملية منْح عمل فني ترجمة لفعل هِبة لا ينتظر منه أي مقابل، مهما كان عند الغريب؛ حتى ولو أنه يكدح من أجل جمع أجزائه المُقْتنَصَة، هنا وهناك في الأماكن المهملة، وترميمها، ومراقبة التغيرات الشكلية واللونية التي تحصل عليها؛ ثم تأثيثها، وتأطيرها في لوحة أو منشأة، والسماح للبعض بمشاهدتها، أو حتى بعرضها. ولكنه يقوم بذلك من منطلق اقتناع راسخ بموقفه وبنمط تواصله مع الآخر، وبإيمان صريح بقيمة اختياراته العملية والجمالية.
يتعلق الأمر، في الأول والأخير، بمسألة اختيار شخصي ذي دلالات أخلاقية. لقد بدا الأمر غريبا، بالفعل، في سياق تَعوَّد على منطق للعرض، والطلب، والتداول، والتبادل، وشكَّل حالة نادرة قياسا إلى ما تواطأ عليه المعنيون بالتصوير والفنون التشكيلية؛ لكن الغريب ينظر إلى عمله باعتباره تجليًا لفعل وجودي وجمالي بالغ الامتلاء والأصالة والاطمئنان الذاتي.
داخل عالمه الصامت، وبشفافيته المفارقة، وبما تَبْعتُه لوحاته وأعماله من توهج، وانبجاس نوراني، يجعل خليل الغريب من التركيز التأملي في فضاء لوحته حالة حيوية، ومجالا لرفض الحدود والمقاسات؛ يتسامى بذلك على الحدثي، والسطحي، والزمني. إنه، في نظر المالح، كائن إيقوني، بحكم استبعاده للغة الطبيعية من مجال اشتغاله، حتى وإن تعلق الأمر بتوقيع اسمه أو تحديد تاريخ لوحته، أو منحها عنوانا. هكذا يريد خليل الغريب التعبير عن حريته من خلال نمط من التمرد، حتى ولو تعلق الأمر بسلطة تسمية اللوحة التي انبثقت من وجدانه وجسده وتوترات عقله.
كيف، إذن، لكاتب مبدع حر -عمران المالح- ألا ينجذب لهذا النمط الفني من ممارسة الحرية الإبداعية، كما يجسدها خليل الغريب في أعماله؟ كيف لفنان متأمل يدخل جمالية مفارقة على مهملات البحر والمجتمع والواقع ألا يثير كاتبا جعل من الفلسفة والفن مصدر معارفه وثقافته؟
يحرك خليل الغريب انجذابا خاصا نحو ما هو فوضوي في أشياء الواقع، نحو ما هو منسي، مُهمل، ومُكسَّر. يلتقطه من الشارع العام، أو من المحلات المنسية ليعطيه انتظاما خاصا داخل لوحته، حيث يمنحه القيمة التي تواطأ الآخرون على تجريدها منه؛ ويتبناه لتشكيل جمالية غير متوقعة. يميل خليل، دوما، إلى استعمال الأشياء البسيطة، ومنها الورق الذي لا يشترط أن يكون من نوعية رفيعة، بالضرورة. فهو يشعر في قرارة نفسه بقدرة لا متحددة على تحويل البسيط والمتواضع إلى مستوى تشكيلي راق. لذلك لا تشعر أمام أعماله بأي شكل من أشكال الادعاء. إن رسمه، كما يقول المالح، حميمي وباطني؛ يعلن عن الغياب والصمت، وعن تلك الحالة التي تقاوم كل فرصة للكلام والحديث لكي تترك المجال للإنشاد الداخلي العميق.
ولعل معاندته للمألوف وللقناعات المشتركة، أو للآراء المتبادلة حول الحياة والمؤسسة والتصوير، هي ما تجعل خليل الغريب يصر على القول إنه ليس رسَّامًا. لا تحركه أية إرادة لتحديد الأشياء أو تسميتها؛ وهو إذ يشكلها ويصوغها تقنيا وجماليا فإنه يقترحها على العين والمشاهدة من دون رغبة منه للبرهنة على أي شيء، أو الدفاع المفهومي عمَّا ينجز.
لقد كان إدموند عمران المالح من بين الأوائل الذين انتبهوا إلى هذا الفنان المتفرد، وكتابه “العين واليد” شكَّل مناسبة لافتة لإثارة الانتباه إلى فنان استثنائي يمثل حالة لا تشبهها أية حالة أخرى في مسار الحركة التشكيلية المغربية. ولا شك أن المالح حين بادر إلى كتابة ما كتَب عن الغريب فقد كانت تحركه اعتبارات فكرية وجمالية قوية، وتواطؤ وجداني مع من يجسد هذا الاستثناء. لم يكن إدموند يكتب عن أي كان، ولا يجامل أحدا بالقياس إلى ما كتب ونشر عن التصوير المغربي. لقد حصل له أن سقط في بعض المطبات بسبب طيبوبته المعهودة، لكن كتاباته وآراءه تكشف عن مثقف موسوعي، وعن متذوق رفيع، وعن متابع ملحاح وحذر جعله يعتبر أن العمل التشكيلي في المغرب عمل يتيم من الكتابة النقدية الرصينة؛ بل إنه كان يرى أنه إذا ما تم استثناء بعض المقالات الجادة، فإن الحيوية الإبداعية لحركة التصوير المغربي لا تجد أمامها سوى “صحراء” نقدية جرداء لا تنبت فيها إلا بعض الأعشاب النحيفة. قد يعثر المرء على بعض الكتابات التي تستحق التنويه بها، ولكن المالح لم يكن يعتبر أنها لا ترقى، على صعيد النقد الفني، إلى مستوى الكثافة الرمزية والتنوع الثقافي التي تقترحه اللوحة المغربية على عين المتلقي أو الناقد.
لا شك أنه، منذ كتابة ما كتبه إدموند عمران المالح، اتخذ المشهد النقدي المغربي تمظهرات واجتهادات وأبعاد جديدة. فما بين المعالجات الصحفية السريعة، وتلك التي يحرص أصحابها على التوثيق والإنصات والمتابعة؛ وما بين ما يكتبه شعراء وكتاب عن أعمال رسامين يجدون فيها ما يحرك أقلامهم واهتمامهم؛ وما بين الكتابات الترويجية التي تُحرَّر تحت الطلب وبمقابلات مغرية؛ فإلى جانب هذه الطرق من التلقي والمواكبة، نجد كتابات رصينة عن المنجز التشكيلي المغربي باللغتين الفرنسية والعربية، وذلك منذ ثلاثة عقود، حيث انخرط أكاديميون ومثقفون في دراسة ما يعرض من أعمال تشكيلية مسلحين بمعرفة فلسفية وجمالية ونقدية سمحت باستجلاء رموز الإبداع البصري ودلالاته وألغازه.
لقد كتب إدموند عمران المالح العديد من المقالات والنصوص عن حركة التصوير المغربي، وخصص فقرات مستفيضة لبعض رواده، ولكنه لم يحصل له أن خصص كتابا لرسام بمفرده. وقد انتظر، بشكل لاإرادي بلا شك، كل الزمن الثقافي الذي عاشه لكي يعثر، في الأخير، على فنان مغمور، أو كان كذلك حين تحرير الكتاب، باعتباره ينشط في مناخ من السرية والكتمان. فكان كتاب “العين واليد”. وكان اللقاء الثقافي والإنساني الحميمي، الذي اشتبكت فيه “عين” المالح ب “يد” الغريب، وتفاعل إدراك الأول مع رموز وشذرات ومنشآت ولوحات الثاني ليوقعا، معا، كتابا في منتهى العمق والجاذبية.
ليس الحديث عن تفرد خليل الغريب مبالغ فيه أو نتاج نزوع انفعالي عابر؛ بل إن نعته ب”الظاهرة” له ما يعلله ويسوغه. فالمرء يجد نفسه أمام فنان عميق، يستند إلى معرفة واطلاع، يمتلك تصورا للمادة وللحياة وللفن؛ تنير مساره “قناعات” لا يتحملها منطق العرض السائد؛ ويستعمل مواد وعناصر لا ينتبه إليها الآخرون، يبني بها مجسماته ولوحاته ومنشآته؛ لا يتعامل بالمواد المعروفة في الصباغة لأنه يستعمل ما هو طبيعي وبسيط، ويستخرج ألوانه وأشكاله منها لكي يمنح المعنى لما يتواطأ الناس على اعتباره من دون قيمة. مُتَنبِّه للتفاصيل الصغيرة، وإن كانت تحركه في الاشتغال عليها أسئلة كبيرة تتعلق بالجسد، والمتعة، والروح، والسلطة، والآخر، والموت.