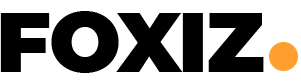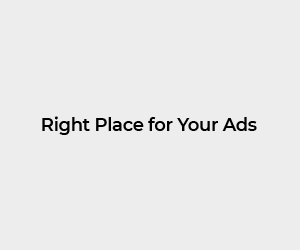قال المنتصر السويني، باحث في العلوم السياسية والمالية العامة، إن نتائج الحسابات الوطنية في المغرب الخاصة بالربع الثاني من السنة الجارية بعثت رسالة سلبية للحكومة والمجتمع، تُشير إلى تنقيط سلبي وحصيلة غير مرضية للسياسات العمومية، وتُظهر أن الاقتصاد الوطني يعيش وضعًا غير صحي.
وقدم السويني، ضمن مقال توصلت به تشاش تفي، معنون بـ”مؤشر النمو بالمغرب ونوعية الأداء الحكومي”، قراءة في أسباب عدم مصالحة الطبقة السياسية المغربية مع النمو، مشددًا على أن الثقافة السياسية للطبقة السياسية المغربية متشبعة بأفكار ومبادئ الديمقراطية التمثيلية، وبالتالي فهي غير متصالحة بالمطلق مع ثقافة النتائج والأرقام والمؤشرات.
وخلص السويني إلى أن المغرب يمضي بسرعتين: سرعة القطار السريع بالنسبة للمؤسسة الملكية، وسرعة بطيئة بالنسبة للمؤسسة الحكومية، وهو ما يؤكده مؤشر النمو المُعلن عنه.
نص المقال:
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية في المغرب الخاصة بالربع الثاني من سنة 2024 تباطؤًا في معدل النمو، حيث انتقل من 2.5% إلى 2.4%. هذا التباطؤ هو رسالة سلبية للفريق الحكومي بالأساس، وللمجتمع كذلك، لأن تراجع النمو أو استقراره يمثل تنقيطًا سلبيًا للأداء الحكومي وحصيلة سلبية للأثر الذي تتركه السياسات العمومية على الحسابات الوطنية.
يعتبر بعض الاقتصاديين من أنصار المحاسبة الوطنية أن الحكومة تكون فاشلة إذا لم يرتفع الناتج الداخلي الخام سنويًا، وإذا لم تحقق التشغيل الكامل، وإذا لم تتحسن القدرة الشرائية وميزان الأداءات. كما يُعتبر تقهُّر البلاد مقارنة بالدول الأخرى علامة سلبية، إضافةً إلى ضعف جودة مؤسسات التعليم التي تحتاجها التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اهتمام القادة السياسيين بتحسين معدلات النمو لتموضع أفضل في سلم الاقتصاد العالمي يعني انتقال فن الحكم من الاعتماد على الخرائط والبوصلة فقط إلى إدماج المؤشرات أيضًا، مما يُضفي أهمية على توقيت الإعلان عن مؤشرات النمو لبلد معين.
اللحظات المرتبطة بالكشف عن الحسابات الوطنية، وخصوصًا المتعلقة بالنمو وارتفاع الناتج الداخلي الخام، تعتبر لحظات محورية في حياة الشعوب والمؤسسات السياسية.
فهي تنقل السياسي من مربع “ديمقراطية الوعود” إلى مربع النتائج، وتحول الفاعل السياسي من زمن إطلاق الوعود إلى زمن الحقيقة المرقمة وديمقراطية النتائج.
1) دور النمو في تعزيز السلم الاجتماعي
الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، جوزيف ستيغليتز، يؤكد أن الاقتناع بالدور الإيجابي للفعل الجماعي كان الدافع وراء تأسيس الدول منذ المجتمعات القديمة. الفعل الجماعي يُحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأفراد، ويساهم في تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
في هذا السياق، يُذكر أن تعميم الانتخاب، الذي بدأ في القرن التاسع عشر، أكد أهمية تحسين الظروف المعيشية للشعوب، كما أشار السياسي الفرنسي ليدرو رولان في عام 1848 عند شرعنة الانتخابات في فرنسا.
من جهة أخرى، يعتبر السوسيولوجي الفرنسي بيير روزنفالون أن مفهوم “التمثيل” في اللغة الدستورية يعني اختيار الحاكمين وتفويض السلطة لهم، ولكن أيضًا نقل مطالب المجتمع وتحقيقها.
2) ارتفاع الناتج الداخلي الخام وترسيخ مبدأ “الحكم هو الحساب”
أزمة 1929 دفعت الدول إلى الاعتماد على المحاسبة الوطنية لتجنب الأزمات الاقتصادية. في عام 1930، طلب وزير التجارة الأمريكي من الاقتصادي سيمون كوزنتس تطوير الحسابات الوطنية، ومنها الناتج الداخلي الخام. هذه الحسابات أصبحت أساسًا لتقييم الأداء السياسي والاقتصادي.
إدماج الحساب والإحصاء ضمن آليات الحكم أكد أن السياسة ليست مجرد خطابات، بل علم دقيق يعتمد على الأرقام والنتائج. هكذا أصبح الناتج الداخلي الخام مقياسًا لتقييم الدول، وتصنيفها حسب قوتها الاقتصادية.
3) رغم الانتقادات الموجهة للناتج الداخلي الخام، يبقى معيارًا عالميًا
النمو وارتفاع الناتج الداخلي الخام لا يزالان معيارين للتقدم الاقتصادي، رغم الانتقادات الموجهة لأساليب حساب الناتج الداخلي الخام. يتجاهل هذا المؤشر بعض الجوانب الاجتماعية والبيئية، ولكنه يظل مؤشرًا هامًا لتقييم الأداء الاقتصادي.
4) قراءة في أسباب عدم مصالحة الطبقة السياسية المغربية مع النمو
الثقافة السياسية للطبقة السياسية المغربية تعتمد على الديمقراطية التمثيلية، التي تركز على العملية الانتخابية وصناعة القوانين، دون الاهتمام الكافي بالنتائج والمؤشرات الاقتصادية. بينما في الديمقراطية الحاكمة، يكون التركيز على تحسين حياة المواطنين من خلال نتائج السياسات العامة.
من جهة أخرى، تعاني الأحزاب الحكومية من ضعف سياسي وتنظيمي. الصراعات الداخلية داخل حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، والعجز عن تقديم أفكار جديدة من قبل حزب الأحرار، جعلت الحكومة غير قادرة على تطوير نموذج فعال للتدبير الحكومي.
الخلاصة:
الحقيقة المرة هي أن المغرب يسير بسرعتين: سرعة القطار السريع بالنسبة للمؤسسة الملكية، وسرعة بطيئة بالنسبة للحكومة، كما يظهر من تراجع مؤشر النمو الأخير. هذا الاختلاف في السرعات يؤكد أن المؤسسات التي تبحث عن المصلحة العامة لا تعمل بالوتيرة نفسها.
ورغم أن دستور 2011 والمؤسسة الملكية منحا استقرارًا معينًا للتشكيلات الحكومية (وهو الاستقرار غير الموجود في غالبية الدول)، كان هذا الاستقرار يستهدف من ورائه العقل المركزي المغربي خلق التوافق الزمني بين الزمن الانتخابي – الأجندة الحكومية – زمن الإشكالات السياسية – زمن الإشكالات التدبيرية، وكان يستهدف كذلك العمل على تمكين الوزراء الذين يعملون على تصور السياسة الحكومية (صياغة البرنامج الحكومي)، السياسة الوزارية والسياسات القطاعية، من العمل كذلك على تنفيذ هذه السياسات ومنحهم الفرصة لتقديم الحساب بشأن هذه السياسات (قانون التصفية مثلًا).
كان من المفروض أن يكون هذا الاستقرار حافزًا للعمل والسرعة وتحقيق النتائج وخلق الثروة وتحقيق النمو برقمين، ولكنه للأسف أفرز نتائج عكسية على التشكيلة الحكومية من خلال البطء وغياب الفعالية وترسيخ الستاتيكو، نظرًا لغياب ثقافة المصالحة مع الأرقام، المؤشرات، والنتائج.
بطء الأداء الحكومي يؤثر بشكل كبير على السرعة التي من المفروض أن يمشي بها المغرب اليوم ليكون قادرًا على بث الأمل وتحسين شروط العيش المشترك.
الآباء المؤسسون للديمقراطية التمثيلية كانوا يعتقدون أن الديمقراطية التمثيلية لوحدها قادرة على تحسين العيش المشترك ونشر الأمل، ولكن يتضح اليوم أن الديمقراطية الحاكمة هي الرافعة الأساسية للدول من أجل تحسين شروط العيش المشترك ونشر الأمل من خلال سرعتها.
أبان نقاش الإصلاح الدستوري لسنة 1992، أكد العميد جورج فيديل أن الديمقراطية التمثيلية لا يجب أن تخنق الديمقراطية الحاكمة (المصطلح الذي ابتكره الباحثان أوليفي ديهاميل وآلان لانصلو). الفقيه الدستوري كان يوجه رسائل مشفرة للمعارضة المغربية التي كانت متشبثة آنذاك بمربع الديمقراطية التمثيلية، لأنها لم تكن قد جُربت بعد في المغرب، بينما كان العميد ينطلق من الأخطاء التي نتجت عن تغول الديمقراطية التمثيلية على الديمقراطية الحاكمة إبان مرحلة الجمهورية الثالثة والرابعة، والنتائج الكارثية لذلك على الاستقرار السياسي والفعالية.
بطء التدبير الحكومي بالمغرب يؤثر بشكل كبير على أداء جزء من الديمقراطية الحاكمة، وبالتالي يطرح السؤال: ما العمل عندما يعجز الحزب المتصدر والأغلبية الحاكمة بالمغرب عن رفع الأداء والسرعة لمواكبة ارتفاع سقف المطالب التنموية، الاقتصادية، والاجتماعية؟ خصوصًا وأن الآلية الدستورية المتمثلة في إمكانية القيام بتعديل حكومي يمس الوزراء فقط قد تكون غير قادرة لوحدها على بعث الروح في الجسد الحكومي البطيء والمتردد، وقد تكون غير قادرة بالتالي على نقل الأداء الحكومي من مرحلة العجز والستاتيكو إلى مرحلة الفعل، السرعة، والنتائج.
وبالتالي، من المفروض اليوم التفكير بشكل جدي في آلية تمكن من القيام بتعديل داخل الولاية يمس كذلك منصب رئيس الحكومة، خصوصًا وأن منصب رئيس الحكومة هو المنصب المفتاح من خلال الصلاحيات المخولة له لرفع السرعة والفعالية الحكومية.
تغيير رئيس الحكومة داخل الولاية التشريعية لن يمس بالبرنامج الحكومي والأهداف المصادق عليهما، وبالتالي لن يمس بالمطالب المعبر عنها إبان اليوم الانتخابي من طرف الشعب الشرعي، مما يفتح المجال لإمكانية تغيير الفريق الحكومي، سواء تعلق الأمر برئيس الحكومة أو بالوزراء في حالة البطء والعجز، خدمة للمصلحة العامة حتى لا يضحي الوطن بمزيد من الوقت، خصوصًا وأن ميزة الديمقراطية الحاكمة أنها ديمقراطية تستمد شرعيتها من خلال الفعل والزمن، وبالتالي يتم اكتشاف فعاليتها من خلال شرعية العمل على أرض الواقع (أي بعديًا) ومن خلال النتائج، على عكس الديمقراطية التمثيلية التي تستمد شرعيتها من خلال التفويض الشعبي (أي قبليًا).
وفي الأخير، ومن أجل الفعالية والسرعة والنتائج، يمكن أن نفسر الدستور بشكل مرن، ويمكن كذلك أن نقوم بتعديل دستوري يستهدف عدم خنق الديمقراطية التمثيلية للديمقراطية الحاكمة.