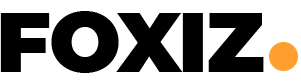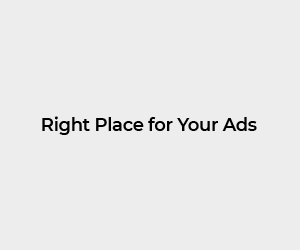قال الأكاديمي المغربي الحسن بوقنطار إن “سنة 2024 كرّست حالة الاضطراب التي يعيشها النظام الدولي، مع أحداث لافتة كعودة دونالد ترامب للرئاسة، وسقوط نظام بشار الأسد، وتوطيد المغرب لوحدته الترابية”، مشيرًا إلى أن “لهذه الأحداث انعكاسات مستقبلية هامة على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية”.
وأشار الحسن بوقنطار في مقال له بعنوان “2024: عودة ترامب وسقوط الأسد وتوطيد الوحدة الترابية”، توصلت به جريدة تشاش تفي الإلكترونية، إلى أن “انتخاب ترامب يعكس تنامي الشعبوية عالميًا، وسقوط نظام الأسد يفتح تساؤلات حول مستقبل سوريا والشرق الأوسط”، مورّدًا أن “موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية عزز الدعم الدولي للوحدة الترابية المغربية، إضافة إلى منح المغرب تنظيم كأس العالم 2030”.
وتناول بوقنطار الموضوع من خلال عدد من المحاور، شملت “انتخاب ترامب: تنامي الشعبوية”، و”سقوط نظام الأسد وتحديات الانتقال”، و”توطيد الوحدة الترابية”، حيث استعرض الأكاديمي المغربي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية لهذه القضايا.
نص المقال:
لم تخل سنة 2024 التي نودعها من أحداث كرّست في مجملها حالة الاضطراب واللايقين التي يعيشها النظام الدولي، الذي يواجه أزمات متعددة، وربما بإكراهات وموارد محدودة. وبقطع النظر عن استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، فإننا سنهتم بأحداث وقعت في السنة التي نودعها، والتي ستكون لها تداعيات مستقبلية. فعلى المستوى العالمي، فإن انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سيباشر عهدته الثانية في 20 يناير المقبل، يظل بمثابة الحدث الذي سيستأثر باهتمام المتتبعين نظرًا لانعكاساته المحتملة على النظام الدولي برمته. وعلى مستوى أقل جغرافيا، فإن ما وقع في سوريا من نهاية لنظام بشار الأسد، يطرح عددًا من التساؤلات، ليس فقط حول مستقبل سوريا، ولكن أيضًا حول تشكّلات النظام الشرق أوسطي. وأخيرًا، لا يمكن أن ننهي هذه القراءة دون التطرق لملف وحدتنا الترابية، الذي تميز بترسيخ المد المعترف بمغربية الصحراء، من خلال الموقف الفرنسي الذي شكّل لبنة أخرى في مسلسل تسوية نهائية تكرس مقاربة الحكم الذاتي كخيار لا بديل عنه. كل ذلك يتزامن مع قرار الفيفا تنظيم المغرب، بمعية إسبانيا والبرتغال، لكأس العالم سنة 2030.
انتخاب ترامب: تنامي الشعبوية
على عكس بعض التوقعات، فقد تمكن دونالد ترامب من تحقيق انتصار كاسح في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نونبر الماضي، تمثل في الفوز بأغلبية أصوات الناخبين، وأيضًا أصوات الولايات الرئيسية، علاوة على مجلسي النواب والشيوخ. ومنذ إزاحته لمنافسيه الجمهوريين في الانتخابات الأولية، بدا واضحًا أن أمريكا دخلت في عهد الترمباوية Trumpism، بكل ما تحمله من إرهاصات الشعبوية المتنامية عبر العالم، والحاملة لمخاطر على مستقبل الحريات والديمقراطية.
عودة ترامب إلى الحكم، كسابقة، جاءت نتيجة لعدة عوامل، من بينها استفادته من مرض وتردد الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، الذي لم يعلن انسحابه من السباق إلا بشكل متأخر. مما جعل المرشحة كامالا هاريس نائبته تبدو وكأنها مرشحة بالضرورة par défaut، مما أفقد الحزب الديمقراطي إمكانية تنظيم انتخابات أولية لفرز مرشحه بشكل مبكر. علاوة على ذلك، فإن حملة الديمقراطيين واجهت ثلاث تحديات:
التحدي الأول ناجم عن طبيعة المرشحة نفسها الملونة القادمة من ولاية كاليفورنيا، المعروفة بثقافتها الليبرالية، في مواجهة نوع من المحافظة السائدة في كثير من الولايات.
التحدي الثاني يكمن في الدفاع عن سياسة أمريكية بدت غير مقبولة لشرائح مختلفة، ولأسباب متباينة، ويتعلق الأمر بالموقف من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث إن الولايات المتحدة تعتبر من أكبر الداعمين ماليًا ولوجستيكيًا لأوكرانيا من خلال نفقات تجاوزت الستين مليار دولار، في الوقت الذي كان المواطن الأميركي يعاني من تبعات التضخم وغلاء الأسعار.
التحدي الثالث يتمثل في صعوبة تبني المرشحة الديمقراطية لبرنامج انتخابي يميزها عن السياسة التي نهجها الرئيس بايدن. بمعنى آخر، وجدت صعوبة واضحة في الكشف عن هوية سياسية خاصة بها.
ينتظر العالم بكثير من الحذر، وربما القلق، السياسة التي سينهجها إزاء عدد من القضايا الشائكة، لا سيما فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، أو العلاقات الاقتصادية الدولية. وقد يعود ذلك بالأساس إلى أسلوبه المستفز، وطبعه صعب التوقع، وإلى تضارب مواقفه التي تنتظر الحسم عندما يبدأ في ممارسة الحكم في 20 يناير المقبل. فهو تارة يعطي الانطباع، على الأقل، من حيث خطابه أن سياسته تنصب بالأساس على الدفاع عن مصالح أمريكا أولًا، وبالتالي سيسعى إلى تقليص تدخلات بلاده الخارجية، والمساهمة أكثر في حل النزاعات الدولية القائمة. لكن أحيانًا أخرى يبدو أكثر عدوانية في التعامل مع بعض الملفات، كما بدا مؤخرًا من مواقفه إزاء قناة بناما، والعلاقات مع كندا التي وصفها باستخفاف على أساس أنها “الولاية الواحدة والخمسون الأميركية”، وكذلك إقليم غرينلاند التابع حاليًا للدنمارك.
من الواضح أن أنظار العالم ستنصب بالأساس على معرفة المقاربة العملية التي سيتبناها فيما يخص الحرب بين أوكرانيا وروسيا. لقد ظل يؤكد على قدرته على حل هذا النزاع في أربع وعشرين ساعة. ولحد الساعة، لم يفصح عن برنامج واضح لذلك، باستثناء دعوته إلى وقف لإطلاق النار، والدخول في مفاوضات. لكن السؤال يبقى مطروحًا حول كيفية إقناع الطرفين بهذه المقاربة، لا سيما أوكرانيا التي تدرك أن أي وقف لإطلاق النار في الظروف الراهنة يعني تجميد الوضع العسكري كما هو عليه. وهو راهن في صالح روسيا. فضلاً عن ذلك، فكل تفاوض في ظل التفوق الروسي الحالي، يفرض على أوكرانيا القبول بالتخلي عن الأراضي، أو على الأقل بعضها، التي احتلتها روسيا، وفي مقدمتها جزيرة القرم، بشكل نهائي.
بصيغة أخرى، ما هي صيغة التسوية الممكنة في ظل تعارض مواقف الطرفين، وكذلك، ما هي حدود القطيعة مع سياسة المساندة المطلقة التي مارستها الإدارة الأميركية السابقة لصالح أوكرانيا، ومدى انعكاس ذلك على مركز أمريكا في العالم، وعلاقاتها مع حلفائها، وكذا تأثير ذلك على موقع القوى المنافسة، وفي مقدمتها الصين الشعبية؟
سقوط نظام الأسد وتحديات الانتقال
كما أسلفنا في مقالة نشرت بهذا الموقع في 10 ديسمبر الحالي، فإن سقوط نظام بشار الأسد في بضعة أيام، شكل مفاجأة كبرى. وبشكل عام، فإن هذا الانهيار يأتي في سياق تراجع حلفائه الثلاث، وهم إيران وحزب الله وروسيا: الأولين بفعل الضربات الإسرائيلية المتوالية، والثالث بفعل تورطه في الحرب مع أوكرانيا المدعومة من طرف الغرب. إضعاف هؤلاء الحلفاء أفقدهم القدرة على مواصلة مساندة نظام فقد الكثير من شعبيته، وظل عاجزًا عن القيام بالإصلاحات الديمقراطية القمينة بإنقاذ نظامه.
لحد الساعة، يحاول قادة النظام الجديد بقيادة السيد أحمد الشرع إعطاء إشارات الطمأنة، خاصة للمحيط الخارجي، على أساس نهج سياسة تقطع مع ممارسة النظام السابق وتستوعب كل الحساسيات التي تشكل المجتمع السوري. وهي إشارات تتوخى بالدرجة الأولى تبديد المخاوف من احتمال تحويل سوريا إلى أفغانستان جديدة، وذلك من خلال تبني صيغة معتدلة للشريعة.
لكن مهمة القادة الجدد ليست باليسيرة في محيط إقليمي ومحلي يغلي بالتحديات. فهناك تساؤلات كبيرة حول هامش المناورة الذي تملكه هذه القيادة الجديدة المسنودة من طرف تركيا. فمن جهة أولى، فهناك تحدي بسط نفوذ الدولة على كافة الإقليم الذي يظل مجزأً بفعل التوترات التي عرفتها البلاد منذ سنة 2011. من المعروف أن جزءًا منها، وخاصة الشمال الشرقي، يظل تحت سيطرة الأكراد. في حين تحاول تركيا الاستفادة من موقعها لدفع الأكراد بعيدًا عن حدودها، وذلك من خلال احتلال أجزاء أخرى كما هو الأمر بالنسبة لمنبج وكوباني.
في نفس الوقت، قامت إسرائيل، ضددًا عن الشرعية الدولية، باحتلال المنطقة العازلة التي كانت تحت سيطرة سوريا في الجولان بموجب قرار للأمم المتحدة صادر في سنة 1972، علاوة على شن غارات لتدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية بدعوى عدم وقوعها تحت سلطة النظام الجديد.
من جهة ثانية، فإن تحقيق هذا الهدف يظل مرتبطًا بنزع أسلحة مختلف الجماعات التي قاتلت ضد النظام السابق. وقد يتطلب هذا الأمر تحويل هؤلاء المقاتلين إلى جنود ضمن جيش وطني يتطلب إعادة البناء من خلال قيادة موحدة. وهو أمر ليس باليسير في ظل تعارض متطلبات تلك الجماعات الجهادية، أو تلك التابعة للأكراد.
من جهة ثالثة، تنتصب أمام القيادة الجديدة مشكلة عودة اللاجئين. وهو ملف معقد، ينضاف إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
فكيف يمكن للسلطات الجديدة إعادة تحريك دواليب الاقتصاد وإعادة بناء المجتمع المليء بالندوب والجراحات الناجمة عن سنوات القمع والحرب والتدخلات الأجنبية؟ يبدو واضحًا أن إعادة تشكيل سوريا تظل حبلى بالمخاطر، ما لم يتجند النظام الدولي من أجل مساعدة البلاد على الخروج من المآزق المختلفة التي تجعل مهمة الانتقال صعبة، ولكن ليست مستحيلة.
توطيد الوحدة الترابية
خلال السنة التي نودعها، تنامت الدينامية الدولية المساندة للوحدة الترابية المغربية. وبعد مرحلة من التوتر والتردد، أدركت فرنسا أن لا مناص لها من الانخراط ضمن المد الداعم لإيجاد تسوية للنزاع المصطنع، على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب إلى مجلس الأمن في سنة 2007، والذي ما فتئ يستقطب مساندة الدول، وخاصة الدول المؤثرة في النظام الدولي.
مما لا شك فيه، فإن الموقف الفرنسي الذي عبرت عنه الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي في 30 يوليو، إلى جلالة الملك محمد السادس، كان في العمق بمثابة تكريس للموقف الفرنسي، وخروج من حالة التردد التي كانت تسم السياسة الفرنسية التي ظلت تبحث عن توازن صعب بين مصالحها في المغرب، وتلك القائمة مع الجزائر.
اقتنعت فرنسا في نهاية المطاف، أن رياح التاريخ تسير مع المقاربة المغربية التي تتوخى بالأساس طي هذا الملف على أساس إقرار ديمقراطي بمشروعية سيادة المغرب. الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي التي تمت في سياق هذا المعطى كرّست بشكل واضح الترابط بين البلدين، والذي تمليه مجموعة من المصالح المشتركة في كثير من المجالات.
بهذا الموقف الفرنسي، أصبحت التوازنات داخل مجلس الأمن الذي يتولى تدبير هذا الملف، تميل أكثر فأكثر لمصلحة بلادنا. وإذا صرفنا النظر عن الصين التي تناهض سياسة التجزئة اعتبارًا لكونها تواجه نفس المعضلة المتعلقة بوحدتها الترابية، فإن الأمل معقود على بريطانيا لكي تنضاف إلى الدول الدائمة العضوية، الداعمة لسيادة المغرب ولفرادة مقترح الحكم الذاتي، كأرضية وحيدة للتفاوض من أجل حل نهائي لهذا النزاع الذي طال أمده، ضدًا عن مصالح شعوب المنطقة في التنمية والديمقراطية. وإذا تحقق ذلك، فمن شأنه أن يدفع مجلس الأمن إلى تطوير قراراته في اتجاه تضمينها هذا المقتضى. وهو ما سيشكل تحوّلًا استراتيجيًا في تعامله، يرسخ أكثر تصوره لهذا النزاع، منذ تقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي.
في الوقت الذي يتدعم مسلسل توطيد الوحدة الترابية، يشكل إعلان الفيفا رسميًا منح المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، فرصة تنظيم كأس العالم لسنة 2030، أفقًا لفتح أوراش جديدة لا تقتصر على المجال الرياضي المحض، بل تتوخى إرساء دعامات إضافية للتنمية، وذلك من خلال تدعيم البنيات التحتية في كثير من المجالات، وكذا زيادة منسوب إشعاع بلادنا في العالم.
لا ريب في أن هذا الورش الكبير يتطلب استثمارات كبيرة، ينبغي أن لا تقتصر على هذا الأفق. بل استحضارًا لتجربة مجموعة من الدول التي سبقتنا في هذا المجال، فإن هناك على الأقل تحديين ينبغي التعامل معهما بالكثير من الحذر. التحدي الأول يكمن في استدامة الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي ستخصص لهذا الحدث. فلا ينبغي أن تكون عبئًا على الأجيال المقبلة، بحيث إن الاستثمارات الكبيرة في الملاعب، خاصة، يمكن أن تبقى بدون مردودية، إذا لم ترافق برؤية تمكنها من أن تكون فضاءات لأنشطة متنوعة، وقابلة للاستغلال المستدام.
وأما التحدي الثاني، فهو يكمن في كون ثمرات هذا التنظيم لا ينبغي أن تبقى مقتصرة على المدن التي ستستقبل المباريات، بل ينبغي أن يكون هناك نوع من الاستفادة العادلة بين مختلف مناطق المغرب، وذلك من خلال ما يمكن تسميته بالإنسيال الإيجابي (Ruisselement). فمن الواضح أن كل المؤشرات تشير حاليًا إلى وجود اختلالات واضحة بين مختلف الجهات، وينبغي أن لا تتعمق هذه الاختلالات أكثر. بل من الضروري السهر على ضمان، ما أمكن، شروط العدالة المجالية.
صفوة القول، إذا كانت سنة 2024 قد شهدت إشارات إضافية على انخراط جزء كبير من المجتمع الدولي في الدينامية التي فتحتها مبادرة الحكم الذاتي بالنسبة للصحراء، فإن الأمل معقود على أن تكون السنة المقبلة لحظة مفصلية في طي هذا الملف بشكل نهائي، في ظل متغيرات نتمنى أن تساهم في إقرار السلم والأمن، ومزيد من التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالنسبة للإنسانية جمعاء.